في «يوم التحرير Liberation Day» أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب «نهاية العولمة» بعد إعلانه فرض 10 في المائة من الجمارك على البضائع الواردة من كل دول العالم إلى الولايات المتحدة. ولكن ذلك كان الفاتحة، فبعد ذلك أقام سلماً جمركياً تفاوت مقداره بين الدول والتكتلات التي تتعامل معها الدولة الأميركية وفي المقدمة منها الصين التي بلغت رسومها الجمركية 54 في المائة وقابلة للزيادة، وبعد ذلك يأتي الاتحاد الأوروبي ودول مجاورة مثل كندا والمكسيك، ودول غزيرة التجارة مع أميركا مثل كوريا الجنوبية وفيتنام. الإعلان جاء معاكساً لتاريخ أميركي طويل، حيث شهدت العقود الثمانية الأولى من القرن العشرين الخروج الأميركي إلى العالم، وممارسة الحرب الساخنة والباردة فيه عالمية أو إقليمية، وجرى ذلك بالتبادل بين الرؤساء الديمقراطيين والجمهوريين منذ تيودور روزفلت وحتى رونالد ريغان؛ وفي ربع القرن الذي تلا تسعينات القرن الماضي وشهد العولمة الأميركية تشمل العالم كله. البداية كانت مع الرئيس الجمهوري جورج بوش الأب، ومن بعده الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون، وكلاهما عمل على إعادة ترتيب الأوضاع العالمية للتعامل مع الاتحاد السوفياتي، وترتيب الأوضاع في أوروبا خصوصاً دول البلقان، ووضع الشرق الأوسط على طريق السلام انطلاقاً من مؤتمر مدريد. بات العالم منسجماً مع التقاليد الأميركية لتحرير التجارة وإنشاء منظمة التجارة العالمية واستيعاب روسيا والصين فيها، وتنظيم انتقال رؤوس الأموال لمواجهة الأزمات المالية الدولية. بات العالم «قرية صغيرة» يشرف على أمنها «الشريف» الأميركي وأقماره الاصطناعية وأسلحته العابرة للقارات والمحيطات. وفي 4 فترات رئاسية أميركية تالية قامت العولمة على أساس أن القرن الحادي والعشرين هو قرن أميركي بالضرورة التي جاء بها «المحافظون الجدد» في عهد جورج بوش الابن الذي انتهى بالأزمة الاقتصادية العالمية في 2008. فترتا باراك أوباما عبَّرت عن الموضوع بمفردات ليبرالية ديمقراطية أرادت ترجمة «العولمة» كي تكون «نهاية» التاريخ الذي بشر به فرنسيس فوكوياما في مطلع التسعينات.
وسط هذه الموجة الضخمة من العولمة التي كانت من أسباب انهيار الاتحاد السوفياتي؛ ومن أسباب صعود الصين؛ ثم دخول كل منهما منظمة التجارة العالمية التي جاءت تبشيراً بعالم واحد بدأ بالاقتصاد في أبعاده المختلفة، لكنه لم ينتهِ بالقيم التي تدافعت من خلال تكنولوجيات متعددة خلقت مجالاً لتفاعل الحضارات التي كانت مهددة بصدام محتوم بشَّر به صمويل هنتنغتون؛ وفي الواقع فإن الحرب «العالمية» ضد الإرهاب شهدت تعاوناً دولياً غير مسبوق في قضايا أمنية؛ وتراجع الإرهاب الذي استعر في هجوم 11 سبتمبر (أيلول) 2001 في نيويورك وواشنطن، والهزيمة الكاملة لدولة الخلافة التي قامت على الحدود السورية - العراقية. الفلسفة «الديالكتيكية» تجاه المادة والفكر تقطع بأن كل أمر ينبت داخله نقيضه، وحدث ذلك مع العولمة، ومن المدهش أن تكون نهايته قادمة من الولايات المتحدة الدولة التي بشرت بالعولمة الكونية، واتُّهمت بوصفها تشكل غطاءً لنوع جديد من الإمبريالية.
العولمة بتفاعلاتها العالمية حققت نمواً غير مسبوق في الاقتصاد العالمي، ومعه تصاعدت أشكال التقدم التكنولوجي، وأصبح الحديث عن العالم يجري بصورة كوكبية تعرف آلام كوكب الأرض، وتخرج عن محيطه إلى الفضاء. «العولمة» باتت تجري بسرعة غير مسبوقة في تاريخ التطورات الإنسانية التي لم يعد ممكناً استيعابها عالمياً. بشكل ما لم يعد ممكناً تلاقي الأفكار اليمينية المعروفة حول دور الدولة في الاقتصاد والمجتمع مع أفكار العولمة، أو حتى ما كان معروفاً بالنظام الدولي المتسم بحرية التجارة. وعلى العكس من ذلك فإن توجهات «اليمين» أصبحت تميل نحو الانعزال والعزلة، والتقوقع داخل شرنقة الدولة القومية مع درجة كبيرة من التوجس في الدول الأخرى بما فيها التي اجتمعت داخل تحالفات واندماجات وتكاملات عابرة للحدود الوطنية. ولم يمضِ وقت طويل حتى بدأت هذه الاتجاهات الجديدة تأخذ أشكالاً عملية ظهرت في الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي فيما بات معروفاً بـ«البريكسيت»، وجاء انتخاب «ترمب الأول» كي يشكل ما هو أكثر من انتخاب رئيس جديد تحت راية اليمين، وإنما ظاهرة متكاملة يمكن نعتها بـ«الأميركسيت» Amerexit. وسواء كان الاتجاه ضد العولمة بريطانياً أم أميركياً فإن سماته كانت الخروج من المنظمات العالمية العابرة للحدود؛ وما طرحته من تفاعلات عدَّتها دول غنية وأغلبيتها بيضاء غير عادلة. ولم يكن الخروج من العولمة الاقتصادية فقط، وإنما برز أيضاً في الخروج من المؤسسات الأمنية الدولية، كما فعلت روسيا بالخروج من المحكمة الجنائية الدولية، ومناداة دول أخرى بضرورة الخروج منها، وخروج الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية. «ترمب الثاني» جاء كي يختم المسألة؛ لكن ذلك لا يعني نهايتها؟!








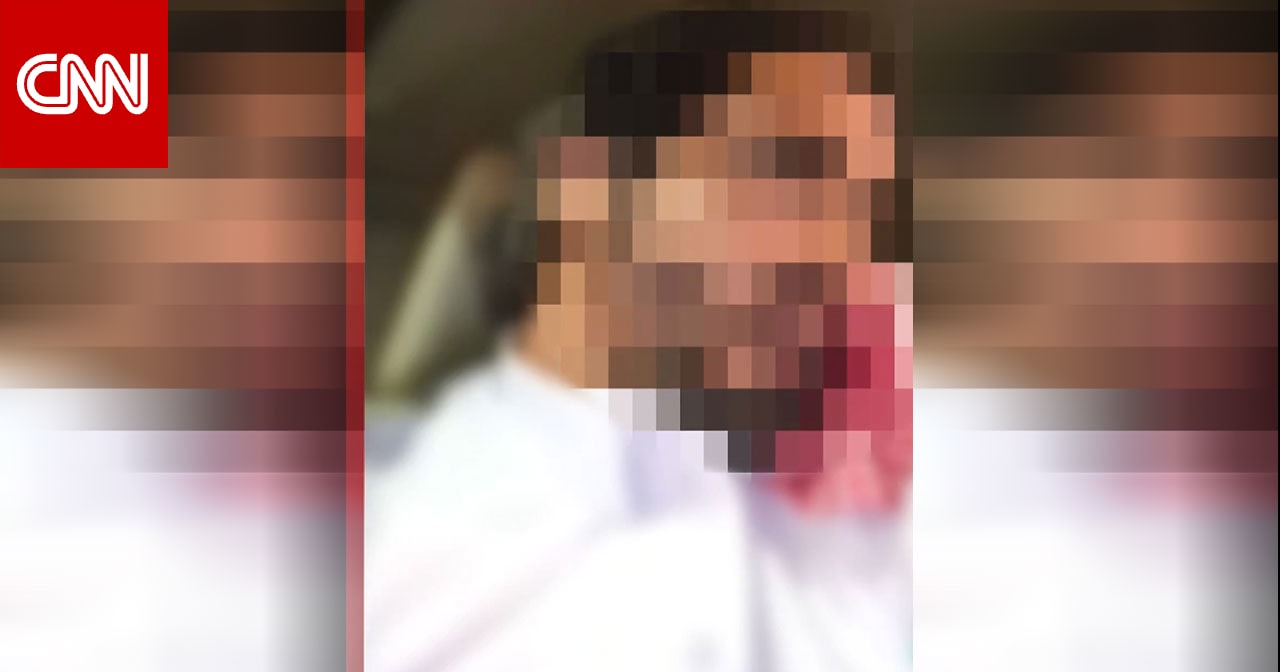

 Arabic (EG)
Arabic (EG)