هيثم المالح لا يعترف بالجمهورية اللبنانية، مع أنه متخصص في القانون الدولي، لا، بل هو «شيخ الحقوقيين». رجل مشاكس، يثير الغبار منذ وصوله إلى سوريا إثر سقوط النظام، خصوصاً حين حاول اعتلاء منبر المسجد الأموي وإلقاء خطاب، من دون تنسيق مسبق، فمُنع. عُرف بدوره معارضاً، وأنه سُجن وعزل من منصبة قاضياً. لكن المالح السياسي الذي عاركته الظروف، يتحدث عن لبنان بتشاوفٍ، ولا يرى فيه سوى قطعة من سوريا يجب أن ترجع إليه، كما كان الحال أيام العثمانيين، حيث لم يكن خارج الجغرافيا السورية غير متصرفية جبل لبنان. أما المليونا نازح سوري الذين استضافهم لبنان بعد الثورة، فهم في رأيه جاءوا إلى أرضهم، وأقاموا في بلادهم. الخلاصة، أن درس صدّام حسين، وطمعه في أرض الكويت، وما جلبه على العرب من كوارث لم يكن كافياً، كي نفهم خطورة الخلط بين التمنيات والوقائع.
كلام المالح، ليس بجديد، نسمعه من كثيرين، ونراه مجرد اندفاعة قومية، عروبية. لكن وللتاريخ، سوريا ولبنان كانا معاً قبل اتفاقية سان - ريمون عام 1920 جزءاً من بلاد الشام التي تضم فلسطين والأردن، وكلها تحت سلطة الدولة العثمانية. اتفاقية سايكس - بيكو السرية عام 1916 رسمت إطاراً عاماً لتوزيع النفوذ في شرق المتوسط، من دون رسم خرائط، وتحديد مساحات. لم تقّسم المنطقة فعلياً، إلا بعد ذلك بأربع سنوات. وما بينهما كان وعد بلفور الذي جلب لنا مصيبة الاحتلال الإسرائيلي الذي جثم على صدورنا. هكذا كانت الدول الاستعمارية تعد العرب، بدولة قومية في بلاد الشام، في الوقت نفسه الذي تجتمع فيه لتقسيم أراضيهم كقطع الحلوى، وتمنح الصهاينة الذين حضروا سان - ريمون حصتهم الوازنة منها.
بقي هذا التقسيم المهين شوكةً في حلق العرب. الإسلاميون يرون فيه مؤامرة كسرت وحدتهم الدينية. الأكراد يعدّونه كارثة محققة قضت على حلمهم بدولة تجلب الرخاء للمنطقة كلها، بدليل ما أنجزوه من نموذج في شمال العراق. تركيا، لم تتوقف عن السعي لاسترداد نفوذها الإمبراطوري.
وبقيت إسرائيل لأكثر من ثلاثة أرباع القرن، المستفيد الأكبر، وربما الوحيد من «سايكس- بيكو»، والتقسيم الذي فُرض عنوة على ملايين العرب. والغريب أنها هي اليوم الأكثر حماسة للتخلص من عبئه. تجدها تجنّد كل طاقاتها، للانقلاب عليه. في خطابه الشهير أمام الكونغرس، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن «يهودا» و«السامرة» الاسمين العبريين للضفة الغربية، جزء لا يتجزأ من «أرض إسرائيل». وأثناء محاكمته بتهم فساد مؤخراً، قال مبتهجاً بالنصر، إن «أمراً تكتونياً يحصل، وزلزالاً لا سابق له من مائة سنة، منذ معاهدة سايكس – بيكو».
محللون إسرائيليون، يقولون إن العرب لم يتقبلوا يوماً «سايكس - بيكو»، وهم باتوا أخيراً، يسيرون في الاتجاه نفسه. لهذا يشعرون بالراحة في التمدد يميناً وشمالاً. كل يوم تشعر إسرائيل أكثر بالرغبة في تحطيم المزيد من الحدود. خرائط «إسرائيل الكبرى» باتت تنشرها وزارة الخارجية الإسرائيلية بشكل رسمي، من دون خجل، غير عابئة باحتجاجات الدول العربية ولا جامعاتهم. هذه المرة، تشمل الخريطة إضافة إلى كل فلسطين، لبنان وسوريا والأردن.
«الشرق الأوسط الجديد» الذي يبشر به نتنياهو، هو انقلاب كامل على «سايكس - بيكو» بتواطؤ من صانعيه الإنجليز والفرنسيين معاً. هو إسقاط للخطوط الحمر والزرق. جزء منه إعلان انتهاء اتفاقية فض الاشتباك في الجولان، مؤخراً، وإسقاط اتفاقية عام 1974، التي أمَّنت الهدوء لعشرات السنين، من طرف واحد.
إسقاط «سايكس - بيكو»، عند إسرائيل، ليس ثرثرة في مقابلة على طريقة المالح، بل هي مليارات الدولارات من العدة العسكرية، للغزو والقتل والاحتلال. لم تكتفِ حكومة الاحتلال بميزانية عسكرية وصلت إلى 27 مليار دولار سنوياً. عيَّنت لجنة «ناغل» الخاصة لفحص الحاجات القتالية المقبلة، فأوصت برفع الميزانية 40 في المائة عما كانت عليه قبل الحرب، وركزت لمزيد من السوريالية، على الخطر السوري المحدق بإسرائيل. هل نضحك أم نبكي؟! كل هذه المليارات لقتال دول مجاورة، لا تملك سوى بدائي الأسلحة، ولا طاقة لها على رد طائرة واحدة، من مئات الطائرات التي تقصفهم بها إسرائيل، ولا دفاعاً جوياً لإسقاط صاروخ واحد.
كانت اتفاقية التقسيم عام 1920 هي واحدة من الاتفاقات العديدة التي غيَّرت العالم في تلك اللحظة التاريخية. فقد سقطت بالتزامن إمبراطوريات وممالك وقامت دول، وأعيد رسم خرائط. وقد نكون في أوانٍ مشابه، ونحن نسمع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، ينطق بما كنا نعتبره سوريالياً، يتحدث عن تغيير أسماء، وضمّ مساحات، وشراء أراضٍ.
لهذا؛ ملاحظة أخيرة للأستاذ هيثم المالح ورفاقه المشغولين بإعادة رسم «سايكس - بيكو» من لبنان: وسّعوا الرؤية، واعتبروا من الماضي. رغم عشقنا للوحدة العربية، فإنها المرة الأولى التي نشعر فيها بأن علينا التمسك بالاتفاقات الاستعمارية المخزية؛ لأن ما ستجلبه إسرائيل أكثر خزياً.






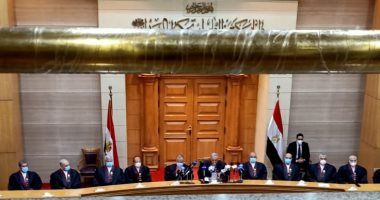



 Arabic (EG)
Arabic (EG)