غريبة هذه البلاد، كيف تتحوّل الأمور البديهية فيها معضلات مستعصية الحلّ. هل من أمر بديهي في العالم أكثر من أن تكون في البلد الواحد دولة واحدة، وسلطة واحدة، وجيش واحد؟ وكيف يمكن أن يقوم بلد، وتنتظم حياته، وتعمل مؤسساته، ويستقر أمنه، وينهض اقتصاده، ويتضح مستقبله، إذا كان فوق أرضه دولتان وجيشان، لكلّ منها آيديولوجيته واستراتيجيته ومؤسساته؟ أمرٌ عجب.
مع ذلك، ما زا
ل اللف والدوران، وسرد الحجج والمطوّلات، وكيل التهم والتهديدات، تدور في لبنان حول ما هو بديهي، لا حاجة للخوض فيه. فلا كيان يُرجى ولا وجود لبلد من دونه: دولة واحدة وسلطة واحدة وجيش واحد فوق أرض واحدة. والمسألة ليست في كون الدولة الواحدة مركزية أو لا مركزية، فيدرالية أو كونفدرالية. علماً بأن الكيان اللبناني هو فيدرالية مجتمعية فوق أرضٍ واحدة منذ نشوئه عام 1861. المسألة الآن في جوهرها هي: دولة أم دولتان؟
ومشكلة الدولتين المستعصية على الحلّ في لبنان ليست وليدة اليوم أو الأمس القريب. هي الترجمة العسكرية للصراع السياسي الدائم بين حركتين أساسيتين رافقتا الكيان اللبناني منذ قيامه قبل 164 عاماً: الحركة اللبنانية، التي أولويتها لبنان وخصوصيته، من جهة، والحركة الإقليمية في لبنان، التي أولويتها محو الخصوصية اللبنانية، ودمجها في مشروع الإقليم. المشروع العثماني، ثم الوحدوي السوري بمختلف أشكاله، من المملكة الفيصلية إلى سوريا الأسدية، ثم المشروع الوحدوي العربي، بصيغه البعثية والقومية العربية والناصرية، والمشروع التحريري الفلسطيني، والمشروع الماركسي الأممي، وأخيراً المشروع الإسلامي الإيراني.
متى انتقل هذا الصراع من طبيعته السياسية الغالبة، إلى طبيعته العسكرية الغالبة، التي بدأت معها شيئاً فشيئاً ثنائية الدولتين فوق الأرض اللبنانية؟
بدأ ذلك قبل ستين عاماً، حين برزت حركة «فتح» مطلع عام 1965 بقيادة ياسر عرفات لإطلاق العمل الفدائي من خارج فلسطين. كان طموح «فتح» أن يكون مسرحها «دول الطوق» التي تزنّر الدولة العبرية. لكن الأنظمة الأمنية في هذه الدول صدّتها بشدّة. فلم تجد أمامها إلّا نافذة واحدة وحيدة تدخل منها: نافذة الحرية اللبنانية. وما لبثت «فتح» أن أطلقت نشاطها الفدائي في العالم من لبنان، وبدأ الكيان الصهيوني ردوده داخل الأراضي اللبنانية. التفّ المشروع الإقليمي في لبنان، بماركسيّيه واشتراكيّيه ووحدويّيه العرب وناصريّيه، حول الحراك العسكري الفلسطيني، الذي استطاع عام 1969 اقتطاع «أرض فتح» في الجنوب، ثم رفعَ شعار «طريق القدس تمرّ في جونية»، وصولاً إلى حرب لبنان التي انطلقت عام 1975، منهيةً أكثر من قرن كامل من «الحلم اللبناني» وإنجازاته الفريدة في كل المجالات، حلّت معها مرحلة الخراب الكبير، بفتنه وحروبه واجتياحاته واحتلالاته وهجراته وأهواله. انهار لبنان ولم تكسب القضية الفلسطينية شيئاً، بل تراجعت أكثر. وكان للعديد من قيادات المشروع الإقليمي، اللبنانيين والفلسطينيين، شرف النقد الذاتي والاعتراف بالخطأ التاريخي في تحميل لبنان أكثر من طاقته بكثير.
وبعيد الثورة الخمينية، دخلت «المقاومة الإسلامية» إلى لبنان عام 1982 من النافذة نفسها، «نافذة الحرية اللبنانية»، لتقيم شيئاً فشيئاً دولتها، فالتفّ المشروع الإقليمي الإيراني الجديد في لبنان حولها، واستطاعت أن تؤلّب جماعات وقوى عديدة، وأن تتسرّب إلى حنايا دولة «لبنان الكبير»، ما أسهم بقوة، في موازاة الطبقة الفاسدة التي لا ترحم، في دفع «بلاد الأرز» إلى الهاوية التي هي الآن فيها، انتهاءً بالحرب الأخيرة وما جرّته من كوارث. والشعار هو نفسه «تحرير القدس واستعادة فلسطين» انطلاقاً من الأرض اللبنانية.
من الواضح منذ البدء أن شعار تحرير فلسطين من لبنان هو شعار عبثي يستفيد من حالة الحريّة اللبنانية ليضحّي بـ«موطن الأرز» من أجل تحقيق مصالح أو أوهام المشاريع الإقليمية المختلفة، من دون أن يضعِف في شيء الدولة العبرية، بل العكس. وهو عبثي ونتائجه معروفة، للسبب الجوهري التالي: كيف لبلد صغير أن يواجه وحيداً من أرضه الحلف العسكري الإسرائيلي الأميركي الأوروبي، بينما هذه المواجهة هي من مسؤولية عدد كبير من الشعوب والأمم، ليس لبنان إلا نقطة في بحرها؟ كيف يكون ذلك، وما النتائج المتوقعة لهذه الحالة الغريبة غير ما نراه ونعيشه؟
وحتى في عام 2000، حين انسحبت الدولة العبرية من لبنان من دون قيد أو شرط، ومن دون مفاوضات مباشرة، أو مطالبة بالتطبيع، بل العودة فقط إلى هدنة 1949، لم يكن المحور الإيراني - السوري مرتاحاً لذلك ولم يقبل به. لأن ثمّة أهدافاً إقليمية أخرى هي الأهم، ولأن وراء أكمة «تحرير القدس واستعادة فلسطين» ما وراءها.





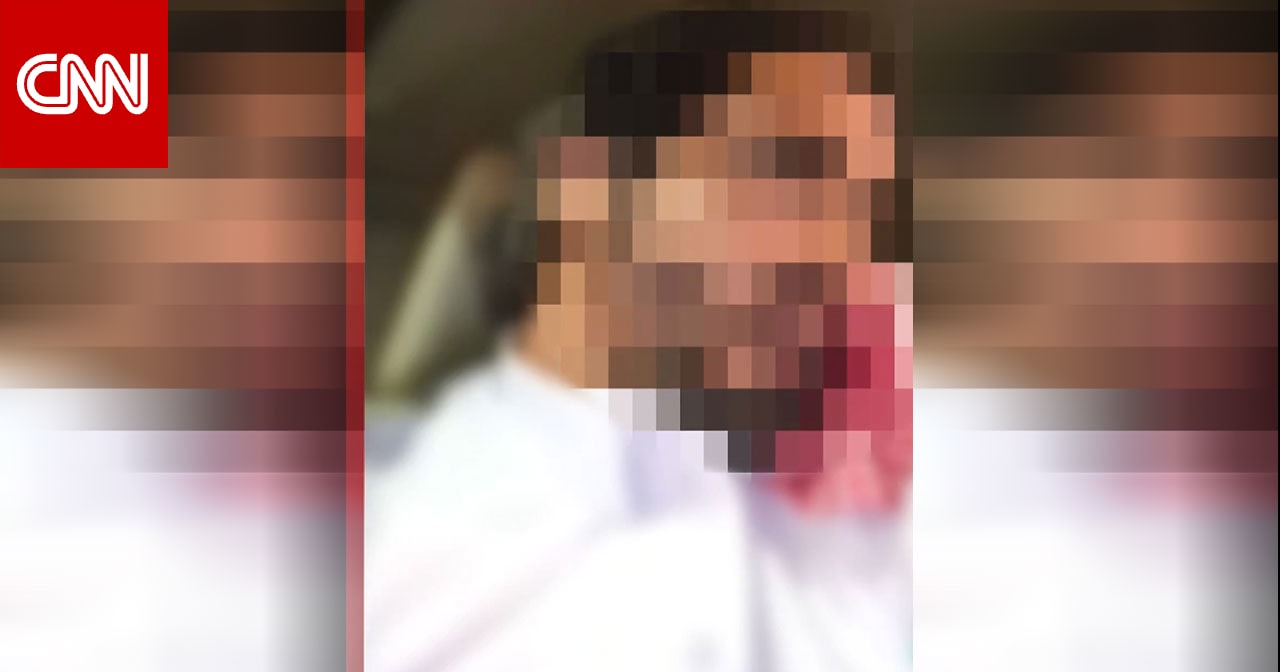




 Arabic (EG)
Arabic (EG)